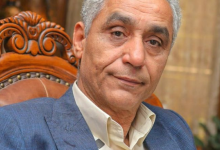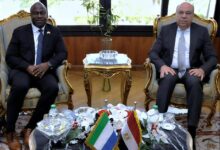د. ميرنا القاضي تكتب: الوجوه الغائبة.. لماذا أخفى المصريون القدماء ملامحهم؟

في حضارةٍ من أعظم حضارات الفن على مرّ العصور، حيث نُقشت آلاف الجداريات، وصُقلت التماثيل على صخور الخلود، يطالعك مشهد غريب…وجوه تشبه بعضها.
ملامح متكررة
تعبير واحد، نظرة واحدة، قناع أبدي، أين هو وجه المصري القديم؟، أين ملامحه الخاصة، بتجاعيد القلق، أو دمعة الفقد، أو ضحكة الحُب؟، هل تعمّد المصريون طمس الوجوه؟، أم أن في الغياب سرًّا؟، وهل كان غياب الملامح في الفن، انعكاسًا لفكرة أعمق: أن الفرد يذوب في الخلود، وأن الهوية الحقيقية لا تُرسم، بل تُعاش في صمت؟.

تشابه الوجوه… لغة موحّدة للخلود
حين تتجوّل في المقابر والمعابد من الدولة القديمة حتى الحديثة، تلاحظ أن، وجه الملك يشبه الإله.
وجه الكاتب يشبه الجندي، وجه المرأة يشبه المرأة الأخرى، كأن الحضارة المصرية قرّرت أن توحّد الملامح… لا من باب التجاهل، بل من باب القداسة.
هل كان الوجه “أداة دنيوية” لا تستحق الخلود؟
أم أن تماثل الوجوه هو دليل على وحدة المصير؟
أم أنها محاولة لصهر الإنسان داخل النمط الكوني الأكبر؟
الفن المصري ليس “بورتريه”… بل “رمز”
الفن المصري لم يكن وصفًا شكليًا، بل لغة رمزية، فكل تفصيلة كانت تحمل رسالة:العين الكبيرة → البصيرة، الكتف العريض → القوة والهيبة، الهدوء الساكن في الملامح → الانتماء للعالم الأبدي.

الرسم لم يكن لتوثيق الملامح، بل لتأكيد مكانة الروح، ولذلك، كان من “العيب الفني” إبراز الاختلافات الجسدية الفردية، لأن الخلود لا يعرف التجاعيد، ولا الانفعالات، ولا العيوب.
الكمال المتعمَّد: الوجه كـ”قناع أبدي”
تأثرت معظم الوجوه الفرعونية بأسلوب “القناع” — وجه بلا تعبير، لكنه يشي بالقوة، والسكينة، والسيطرة، خصوصًا في تماثيل الآلهة والملوك، حيث، تُغلق الشفاه بإحكام، العينان نصف مفتوحتين، الهدوء مهيب، كأن الروح لا تتحرّك بل “ترقب”، هل كانوا يرسمون وجه الموت؟، أم وجه الروح عندما تتحرر من الانفعال؟
الاستثناءات التي تؤكّد القاعدة
ومع ذلك، هناك لحظات نادرة كُشف فيها الوجه الحقيقي، تمثال شيخ البلد (من الدولة القديمة) بعينين من النحاس والكوارتز مرعبتي الواقعية، سنوسرت الثالث بوجه منهك، يحمل نظرة قلقة تشبه القادة في لحظة الشك، رعحوتب ونوفرت بوجوه مشرقة، لا تمثّل طبقة ملوكية، بل طبقة متوسطة… أكثر واقعية وأقرب للحياة.
لكن… هذه الحالات تظل استثنائية، وكأن المصري القديم يسمح للملامح أن تظهر فقط عندما تكون الرسالة هي الإنسان نفسه، لا الخلود.
الدولة الحديثة: تماهي الإله والملك
مع الدولة الحديثة، خصوصًا في عهد تحتمس الثالث ورمسيس الثاني، تصبح ملامح الملوك أكثر اتقانًا وتماثلًا، لكن أقل خصوصية، الملك يصبح شبه إله، بل أحيانًا نسخة أرضية من حورس، لذلك يجب أن، يظهر بشباب دائم، يحمل وجهًا مثاليًا، لا يعبر عن حزن أو تعب أو حتى نصر، يكون قناعًا للوظيفة المقدسة، لا مرآة للنفس، ثم تأتي لحظة مثيرة مع أخناتون، الذي كسر هذه القاعدة تمامًا.
أخناتون: التشويه المقدّس؟
في عهد أخناتون، نرى ملامح ملك بوجه ممدود، بطن بارز، صدر أنثوي الشكل، وعيون حزينة، هل كان ذلك تشويهًا واقعيًا؟، أم إعادة رسم للملك ككائن يتجاوز الذكر والأنثى، الأرض والسماء؟، ربما أراد أخناتون أن يُجسّد فكرة التوحيد في ملامحه، أن يكون الجسد جامعًا للأضداد، كما كان إلهه آتون نورًا لا يُحتَكر ولا يُصوّر. وفي ذلك، لم يكن التشويه ضعفًا بل إعلانًا عن تحوّل الهوية من “وظيفة سياسية” إلى “رسالة وجودية”.

هنا، استخدم الفن الفرعوني الملامح الفردية كأداة فلسفية… لكنها ظلت محصورة في عهد هذا الملك وحده، ثم عادت الأمور بعدها إلى تماثلها الأيقوني.
قناع توت عنخ آمون: الكمال الذي يُخفى الهوية
قناع توت عنخ آمون الشهير، المصنوع من الذهب واللازورد، مثال صارخ على “الهوية–القناع”، لم يُنحت القناع ليشبه وجه توت الحقيقي، بل نُحت ليمثّل الوجه الذي يجب أن يكون عليه في الأبدية.
ملامحه ناعمة، متزنة، لا تنتمي لطفل، ولا لرجل، بل تمثّل “المُتحوِّل إلى أوزير”، إنّه وجه الخلود، لا الحياة، وإن لم نرَ ملامح توت، فقد رأينا صورته في الخلود.

النقلة المفاجئة
بورتريهات الفيوم، “ثم… حدث ما لم يكن في الحسبان، بعد آلاف السنين من الأوجه المتشابهة، ينبثق من قلب النسيان وجهٌ بشريّ حقيقي، يشبهنا. ينظر إلينا.”، في القرون الأخيرة من العصر الفرعوني (خاصة في العصر الروماني–المصري)، تظهر فجأة لوحات تُرسم بالألوان على الخشب، تُثبَّت على وجوه المومياوات، تُظهر ملامح دقيقة، واقعية، مؤثّرة، وجوه لرجال ونساء، بشفاه مكتنزة، نظرات حادة، خدود مورّدة، تجاعيد خفيفة، كل بورتريه يبدو كشخص حيّ يتكلم من عينيه، لماذا ظهرت هذه الوجوه بعد آلاف السنين من الغياب؟، هل تغيّرت نظرة المصري للحياة والموت؟، أم أنها نتيجة تداخل الثقافات (اليونانية والرومانية) مع التقاليد المصرية؟، ربما.
لكن الأغرب، أن هذه الوجوه لم تُرسم في الحياة، بل بعد الموت، كأن المصري أخيرًا قرر أن يواجه الموت بوجهه الحقيقي… لا بصورة إلهه.
في النهاية، يبدو أن الفن المصري مرّ بدورة كاملة:
من “طمس الملامح” في سبيل الخلود، إلى “تجريد الهوية” لصالح الرمز، ثم العودة بـ”الوجه الفردي” كبصمة نهائية تُرسل إلى الأبد، لكن، إذا كان الفن انعكاسًا للفكر، فهل عاش المصري القديم بلا وجه؟، ربما نعم… لكنه لم يكن بلا هوية.

ففي فلسفة “ماعت”، لم تكن الفردانية غاية، بل كان الإنسان جزءًا من نظام كوني متوازن، هو خيط في نسيج الأبدية، والهوية لم تكن شكلاً يُرى، بل دورًا يُؤدى، وصفة تُجسّد، وانتماءً روحيًا لا يُمحى.
ربما كان المصري القديم يعرف ما لا نعرفه، أن الوجه الحقيقي لا يُرسم على الحجر، ولا ينعكس في المرايا، ولا يُخلّد في التماثيل، بل يظهر فقط عندما تعبر الروح بوابة الأبدية.
ولذلك، لم يتركوا لنا وجوههم، بل تركوا لنا رسالتهم، “وجهي هناك، في ضوء الأبد، لا في ظلّ الأرض.”